بسم الله الرحمن الرحيم
من كتاب
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنـزيه
محمد أمان الجامي - رحمه الله -
قال العلامة الجامي رحمه الله : (وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من (نصيحته) التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق، فتاب، وربما أكثرت النقل عنه. والذي حملني على ذلك أنني لم أجد فيمن رجعوا إلى منهج السلف من علماء الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمن، من هو أصرح منه رجوعاً، ولا أصدق منه نصحاً لمن تركهم خلفه من الشيوخ، ولا أدق منه فهماً لمنهج السلف الصالح، ولا أشد منه حرصاً على رجوع مشايخه إلى منهج السلف، كما لم أجد من صوّر تصويراً دقيقاً الأسباب التي حملت شيوخه وأمثالهم على الإصرار على تأويل صفات الأفعال، والصفات الخبرية. بل لم أجد أحداً يقاربه في هذه المعاني. وهي المعاني التي امتاز بها والد إمام الحرمين، وبالتالي هي المعاني التي حملتني على إكثار النقل من كلامه، رحمه الله)
"يقول الإمام الجويني (الأب) رحمه الله بعد مقدمة مستفيضة، سرد منها كثيراً من صفات الله وأسمائه:
وبعد: فهذه نصيحة كتبتها[1] إلى إخواني في الله أهل الصدق، والصفاء، والإخلاص، والوفاء، لما تعيّن عليّ من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله عز وجل، فإنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.[2] وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة"ثلاثا، قالوا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".[3] أعرفهم - أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده - أنني كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث مسائل:
1- مسألة الصفات 2- ومسألة الفوقية 3- ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد.
وكنت متحيراً في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في إثبات الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدَمِ صدق عند ربهم، وأمثال ذلك.
ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم.
وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها، قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه. وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة، يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم.
ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات (حزازات) لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول، مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي.
ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها، لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء - مشايخي الفقهاء- المتكلمون، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، والنزول بنزول الأمر، وغير ذلك.
ولم أجد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه، من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم تنقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أُخَر باطنة غير ما يظهر من مدلولها، مثل الفوقية القهرية، ويد النعمة، وغير ذلك.
وأجد الله عز وجل يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}[4]، {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}[5]، {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ}[6]، {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}[7]، {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ}[8]، {أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا}[9].
فسرد آيات كثيرة كلها تدل على فوقية الله وعلوه على خلقه، إلى أن قال: ثم أجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث للجارية: "أين الله؟" فقالت: في السماء[10]. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه، فلا يتوهمون أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال: "اعتقها فإنها مؤمنة".
وفي حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة" وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى القبة.
وساق عدة أحاديث وسيأتي ذكرها في موضعها.
إلى أن قال: لا ريب إننا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك، هي صفات كما تليق به، لا كما تليق بنا، فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفاً، وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضاً بل هو كما يليق به.
ومثل ذلك بعينه: فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة، أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإنهما معلومان ولا يكيفان. وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما تليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله.
وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد. فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه أعمى من وجه، مبصراً من حيث الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. ولا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر، الكل ورد فيه النص.
فإن قالوا لنا في الاستواء: شبهتم. نقول لهم: في السمع شبهتم، ووصفتم ربكم بالعرض. وإن قالوا: لا عرض، بل كما يليق به.قلنا في الاستواء والفوقية: لا عرض، بل كما يليق به.
فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب، نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما لا يجعلونها أعراضاً كذلك نحن لا نجعلها جوارح، ولا مما يوصف به المخلوق.
وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين، فيحتاجون إلى التأويل والتحريف.
فإن فهموا من هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع، صفات المخلوقين من الأعراض، فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه الصفات من العرضية، وما ينـزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء.
ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقده، وقبل نصيحتنا ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد، وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك، وحرفنا هذه وأولنا، كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى.
هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصحه الإمام الجويني شيوخه الذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف في صفات الله تعالى كلها، أو التصرف فيها بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر، ثم تاب الله عليه فتاب، وكتب هذه (النصحية) التي انتخبنا منها بعض النقاط من أولها ومن آخرها، وقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية والعقلية معاً، وطالبهم بالإنصاف - والإنصاف من الإيمان - وأوضح لهم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما أولوه وحرفوا فيه الكلام، وبين ما أثبتوه من الصفات، لأن هذه وتلك جاءت في موضع واحد وهو الوحي من كتاب أو سنة، ودرج على عدم التفريق بينها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الحديث.
ثم أوضح السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويلهم صفات الله تعالى عامة، والصفات الخبرية السمعية خاصة. وهو أنهم فهموا منها خطأ المعاني التي تليق بالمخلوق، ثم أرادوا تصحيح ذلك المفهوم الخاطئ فوقعوا في التأويل، أي شبهوا أولاً ثم عطلوا ثانياً، هذه هي حقيقة القوم وعقيدتهم.
فنسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لهذا الإمام وأمثاله على هذه النصحية الهادئة والصادقة، إنه سميع قريب.
فليهنأ أبو محمد الجويني بهذا التوفيق وهذه الهداية، ولعل الله علم من الرجل الإخلاص في علمه وجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة (حيرته وتردده) تلك الفترة الصعبة على قصرها - فيما أحسب - فهداه الله ووفقه مصداقاً لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}، ولقد كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد ليحولا بينه وبين رؤية الحق واتباعه {وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ} ووفقه بيده إلى بر السلامة، فسلم ونحمد الله على ذلك.
إذ قارن الإمام بين ما يخوض فيه شيوخه من التأويل، وبين ما ينطق به الكتاب المبين والسنة المطهرة من إثبات حقائق الصفات، فتأكد أن شيوخه لم يفهموا نصوص الصفات الفهم الصحيح، لا سيما الصفات الخبرية، بل لم يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك تورطوا في التحريف والتعطيل أو الوقوف دون محاولة للفهم، لذا بادر الإمام أبو محمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته وسلوكه مسلك السلف على بصيرة من ربه[11].
[1] هذه الرسالة توجد ضمن مجموعة الرسائل (المنيرية)، وهي خير ما كتب في بابها، وكاتبها خير من رجع إلى الحق، ثم نصح، كما فعل ذلك إمامه الأشعري قبله، ورسالته خير من الإبانة للإمام الأشعري في عرض منهج السلف، وخاصة المسائل التي اختارها؛ فتحدث عنها رحمة الله عليه.
[2] أخرجه البخاري في الإيمان 1/147، طبعة الحلبي مع الفتح.
[3] أخرجه مسلم في صحيحه 1/37، شرح النووي، الطبعة الأولى.
[4] سورة طه آية 5.
[5] سورة الأعراف آية 53.
[6] سورة النحل آية 50.
[7] سورة فاطر آية 10.
[8] سورة الملك آية 16.
[9] سورة الملك آية 17.
[10] أخرجه مسلم.
[11] وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من (نصيحته) التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق، فتاب، وربما أكثرت النقل عنه. والذي حملني على ذلك أنني لم أجد فيمن رجعوا إلى منهج السلف من علماء الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمن، من هو أصرح منه رجوعاً، ولا أصدق منه نصحاً لمن تركهم خلفه من الشيوخ، ولا أدق منه فهماً لمنهج السلف الصالح، ولا أشد منه حرصاً على رجوع مشايخه إلى منهج السلف، كما لم أجد من صوّر تصويراً دقيقاً الأسباب التي حملت شيوخه وأمثالهم على الإصرار على تأويل صفات الأفعال، والصفات الخبرية. بل لم أجد أحداً يقاربه في هذه المعاني. وهي المعاني التي امتاز بها والد إمام الحرمين، وبالتالي هي المعاني التي حملتني على إكثار النقل من كلامه، رحمه الله." ا.هـ




من كتاب
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنـزيه
محمد أمان الجامي - رحمه الله -
قال العلامة الجامي رحمه الله : (وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من (نصيحته) التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق، فتاب، وربما أكثرت النقل عنه. والذي حملني على ذلك أنني لم أجد فيمن رجعوا إلى منهج السلف من علماء الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمن، من هو أصرح منه رجوعاً، ولا أصدق منه نصحاً لمن تركهم خلفه من الشيوخ، ولا أدق منه فهماً لمنهج السلف الصالح، ولا أشد منه حرصاً على رجوع مشايخه إلى منهج السلف، كما لم أجد من صوّر تصويراً دقيقاً الأسباب التي حملت شيوخه وأمثالهم على الإصرار على تأويل صفات الأفعال، والصفات الخبرية. بل لم أجد أحداً يقاربه في هذه المعاني. وهي المعاني التي امتاز بها والد إمام الحرمين، وبالتالي هي المعاني التي حملتني على إكثار النقل من كلامه، رحمه الله)
من كلام الإمام الجويني (الأب) في رسالته التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه إلى مذهب السلف
"يقول الإمام الجويني (الأب) رحمه الله بعد مقدمة مستفيضة، سرد منها كثيراً من صفات الله وأسمائه:
وبعد: فهذه نصيحة كتبتها[1] إلى إخواني في الله أهل الصدق، والصفاء، والإخلاص، والوفاء، لما تعيّن عليّ من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله عز وجل، فإنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.[2] وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة"ثلاثا، قالوا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".[3] أعرفهم - أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده - أنني كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث مسائل:
1- مسألة الصفات 2- ومسألة الفوقية 3- ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد.
وكنت متحيراً في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في إثبات الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدَمِ صدق عند ربهم، وأمثال ذلك.
ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم.
وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها، قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه. وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة، يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم.
ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات (حزازات) لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول، مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي.
ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها، لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء - مشايخي الفقهاء- المتكلمون، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، والنزول بنزول الأمر، وغير ذلك.
ولم أجد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه، من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم تنقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أُخَر باطنة غير ما يظهر من مدلولها، مثل الفوقية القهرية، ويد النعمة، وغير ذلك.
وأجد الله عز وجل يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}[4]، {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}[5]، {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ}[6]، {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}[7]، {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ}[8]، {أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا}[9].
فسرد آيات كثيرة كلها تدل على فوقية الله وعلوه على خلقه، إلى أن قال: ثم أجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث للجارية: "أين الله؟" فقالت: في السماء[10]. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه، فلا يتوهمون أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال: "اعتقها فإنها مؤمنة".
وفي حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة" وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى القبة.
وساق عدة أحاديث وسيأتي ذكرها في موضعها.
إلى أن قال: لا ريب إننا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك، هي صفات كما تليق به، لا كما تليق بنا، فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفاً، وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضاً بل هو كما يليق به.
ومثل ذلك بعينه: فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة، أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإنهما معلومان ولا يكيفان. وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما تليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله.
وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد. فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه أعمى من وجه، مبصراً من حيث الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. ولا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر، الكل ورد فيه النص.
فإن قالوا لنا في الاستواء: شبهتم. نقول لهم: في السمع شبهتم، ووصفتم ربكم بالعرض. وإن قالوا: لا عرض، بل كما يليق به.قلنا في الاستواء والفوقية: لا عرض، بل كما يليق به.
فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب، نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما لا يجعلونها أعراضاً كذلك نحن لا نجعلها جوارح، ولا مما يوصف به المخلوق.
وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين، فيحتاجون إلى التأويل والتحريف.
فإن فهموا من هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع، صفات المخلوقين من الأعراض، فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه الصفات من العرضية، وما ينـزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء.
ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقده، وقبل نصيحتنا ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد، وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك، وحرفنا هذه وأولنا، كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى.
هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصحه الإمام الجويني شيوخه الذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف في صفات الله تعالى كلها، أو التصرف فيها بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر، ثم تاب الله عليه فتاب، وكتب هذه (النصحية) التي انتخبنا منها بعض النقاط من أولها ومن آخرها، وقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية والعقلية معاً، وطالبهم بالإنصاف - والإنصاف من الإيمان - وأوضح لهم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما أولوه وحرفوا فيه الكلام، وبين ما أثبتوه من الصفات، لأن هذه وتلك جاءت في موضع واحد وهو الوحي من كتاب أو سنة، ودرج على عدم التفريق بينها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الحديث.
ثم أوضح السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويلهم صفات الله تعالى عامة، والصفات الخبرية السمعية خاصة. وهو أنهم فهموا منها خطأ المعاني التي تليق بالمخلوق، ثم أرادوا تصحيح ذلك المفهوم الخاطئ فوقعوا في التأويل، أي شبهوا أولاً ثم عطلوا ثانياً، هذه هي حقيقة القوم وعقيدتهم.
فنسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لهذا الإمام وأمثاله على هذه النصحية الهادئة والصادقة، إنه سميع قريب.
فليهنأ أبو محمد الجويني بهذا التوفيق وهذه الهداية، ولعل الله علم من الرجل الإخلاص في علمه وجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة (حيرته وتردده) تلك الفترة الصعبة على قصرها - فيما أحسب - فهداه الله ووفقه مصداقاً لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}، ولقد كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد ليحولا بينه وبين رؤية الحق واتباعه {وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ} ووفقه بيده إلى بر السلامة، فسلم ونحمد الله على ذلك.
إذ قارن الإمام بين ما يخوض فيه شيوخه من التأويل، وبين ما ينطق به الكتاب المبين والسنة المطهرة من إثبات حقائق الصفات، فتأكد أن شيوخه لم يفهموا نصوص الصفات الفهم الصحيح، لا سيما الصفات الخبرية، بل لم يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك تورطوا في التحريف والتعطيل أو الوقوف دون محاولة للفهم، لذا بادر الإمام أبو محمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته وسلوكه مسلك السلف على بصيرة من ربه[11].
[1] هذه الرسالة توجد ضمن مجموعة الرسائل (المنيرية)، وهي خير ما كتب في بابها، وكاتبها خير من رجع إلى الحق، ثم نصح، كما فعل ذلك إمامه الأشعري قبله، ورسالته خير من الإبانة للإمام الأشعري في عرض منهج السلف، وخاصة المسائل التي اختارها؛ فتحدث عنها رحمة الله عليه.
[2] أخرجه البخاري في الإيمان 1/147، طبعة الحلبي مع الفتح.
[3] أخرجه مسلم في صحيحه 1/37، شرح النووي، الطبعة الأولى.
[4] سورة طه آية 5.
[5] سورة الأعراف آية 53.
[6] سورة النحل آية 50.
[7] سورة فاطر آية 10.
[8] سورة الملك آية 16.
[9] سورة الملك آية 17.
[10] أخرجه مسلم.
[11] وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من (نصيحته) التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق، فتاب، وربما أكثرت النقل عنه. والذي حملني على ذلك أنني لم أجد فيمن رجعوا إلى منهج السلف من علماء الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمن، من هو أصرح منه رجوعاً، ولا أصدق منه نصحاً لمن تركهم خلفه من الشيوخ، ولا أدق منه فهماً لمنهج السلف الصالح، ولا أشد منه حرصاً على رجوع مشايخه إلى منهج السلف، كما لم أجد من صوّر تصويراً دقيقاً الأسباب التي حملت شيوخه وأمثالهم على الإصرار على تأويل صفات الأفعال، والصفات الخبرية. بل لم أجد أحداً يقاربه في هذه المعاني. وهي المعاني التي امتاز بها والد إمام الحرمين، وبالتالي هي المعاني التي حملتني على إكثار النقل من كلامه، رحمه الله." ا.هـ









 Selected Sites
Selected Sites Videos Section
Videos Section Audios Section
Audios Section Selected Books
Selected Books Selected Articles
Selected Articles
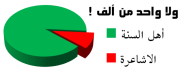








0 comments:
إرسال تعليق